تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية
تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةpdf
تعددت المناهج النقدية الحديثة في هذه الأيام، وتبعاً لذلك فقد تعددت أساليب (تحليل الخطاب الأدبي) بتعدد هذه المناهج التي تختلف في منطلقاتها ومفاهيمها ومصطلحاتها.
وإذا كانت (البنيوية) قد انطلقت في النصف الثاني من القرن العشرين فملأت الدنيا وشغلت الناس، فإنها بدأت بالتراجع منذ إضرابات الطلاب الراديكالية في فرنسا عام 1968، مما جعل البنيويين يعيدون النظر في مواقفهم ومنهجهم الذي خرجت من رحمه مناهج نقدية عديدة كالأسلوبية، والسيميائية، والتفكيكية، بالإضافة إلى الألسنية، التي هي عماد هذه المناهج النقدية جميعاً.
و(الإشكال) الذي أوقعتنا البنيوية فيه هو أنها اندلعت علينا دفعة واحدة مع المناهج النقدية الحداثية الأخرى التي استقلت عنها فيما بعد. وقد أشاعت هذه (التعددية) الاضطراب المنهجي، أثناء تلقينا لهذه المناهج التي جوبهت بالعداء منذ وصولها، لأنها زعزعت الثوابت النقدية المطمئنة التي كنا نستند إليها، مما أصاب الكثيرين منا بعسر هضم مفاهيمها ومصطلحاتها.
بيد أن كثيراً من نقادنا آمن فيما بعد، بالبنيوية، وبغيرها من المذاهب النقدية الحداثية الوافدة، فاعتمدها في عمله النقدي، في تحليل النصوص الشعرية والسردية. ولكن قليلاً منهم مَنْ أخلص لها تماماً، ولعل السبب في ذلك هو عدم استيعاب مبادئها ومصطلحاتها، واختلاطها بغيرها من المناهج النقدية، وعدم اكتمال هذا المنهج، لأنه يُبنى في كل يوم باجتهادات متبنيه، مما جعل كثيراً من نقادنا يزاوجون، في ممارساتهم النقدية، بين أكثر من منهج نقدي، كما فعل الغذامي في جمعه بين البنيوية والتشريحية، وكمال أبو ديب في جمعه بين البنيوية والتفكيكية، وعبد الملك مرتاض في جمعه بين البنيوية والتقليدية.
وفي كتابنا هذا حاولنا رصد تلقينا لهذا المنهج البنيوي، بتياريه: (الشكلي)، و(التكويني)، في مستوياته الثلاثة: التنظيرية الغربية، والتنظيرية العربية، والتطبيقية. آملين أن نُسهم في جلاء غوامض هذا المنهج النقدي، والله الموفق.
وإذا كانت (البنيوية) قد انطلقت في النصف الثاني من القرن العشرين فملأت الدنيا وشغلت الناس، فإنها بدأت بالتراجع منذ إضرابات الطلاب الراديكالية في فرنسا عام 1968، مما جعل البنيويين يعيدون النظر في مواقفهم ومنهجهم الذي خرجت من رحمه مناهج نقدية عديدة كالأسلوبية، والسيميائية، والتفكيكية، بالإضافة إلى الألسنية، التي هي عماد هذه المناهج النقدية جميعاً.
و(الإشكال) الذي أوقعتنا البنيوية فيه هو أنها اندلعت علينا دفعة واحدة مع المناهج النقدية الحداثية الأخرى التي استقلت عنها فيما بعد. وقد أشاعت هذه (التعددية) الاضطراب المنهجي، أثناء تلقينا لهذه المناهج التي جوبهت بالعداء منذ وصولها، لأنها زعزعت الثوابت النقدية المطمئنة التي كنا نستند إليها، مما أصاب الكثيرين منا بعسر هضم مفاهيمها ومصطلحاتها.
بيد أن كثيراً من نقادنا آمن فيما بعد، بالبنيوية، وبغيرها من المذاهب النقدية الحداثية الوافدة، فاعتمدها في عمله النقدي، في تحليل النصوص الشعرية والسردية. ولكن قليلاً منهم مَنْ أخلص لها تماماً، ولعل السبب في ذلك هو عدم استيعاب مبادئها ومصطلحاتها، واختلاطها بغيرها من المناهج النقدية، وعدم اكتمال هذا المنهج، لأنه يُبنى في كل يوم باجتهادات متبنيه، مما جعل كثيراً من نقادنا يزاوجون، في ممارساتهم النقدية، بين أكثر من منهج نقدي، كما فعل الغذامي في جمعه بين البنيوية والتشريحية، وكمال أبو ديب في جمعه بين البنيوية والتفكيكية، وعبد الملك مرتاض في جمعه بين البنيوية والتقليدية.
وفي كتابنا هذا حاولنا رصد تلقينا لهذا المنهج البنيوي، بتياريه: (الشكلي)، و(التكويني)، في مستوياته الثلاثة: التنظيرية الغربية، والتنظيرية العربية، والتطبيقية. آملين أن نُسهم في جلاء غوامض هذا المنهج النقدي، والله الموفق.
↚
المستوى التنظيري الغربية
للبنيوية الشكلية
المصادر
نشأت البنيوية في فرنسا، في منتصف الستينيات من القرن العشرين عندما ترجم (تودوروف) أعمال الشكليين الروس إلى الفرنسية. فأصبحت أحد مصادر البنيوية.
ومن المعلوم أن مدرسة (الشكليين الروس) ظهرت في روسيا بين عامي 1915 و1930، ودعت إلى الاهتمام بالعلاقات الداخلية للنص الأدبي، واعتبرت الأدب نظاماً ألسنياً ذا وسائط إشارية (سيميولوجية) للواقع، وليس انعكاساً للواقع. واستبعدت علاقة الأدب بالأفكار والفلسفة والمجتمع. وقد طورت البنيوية بعض الفروض التي جاء بها الشكليون الروس.
المصدر الثاني الذي استمدت منه البنيوية هو (النقد الجديد) الذي ظهر في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين في أمريكا، فقد رأى أعلامه "أن الشعر هو نوع من الرياضيات الفنية" (عزرا باوند)، وأنه لا حاجة فيه للمضمون، وإنما المهم هو القالب الشعري (هيوم)، وأنه لا هدف للشعر سوى الشعر ذاته (جون كرو رانسوم).
والألسنية هي المصدر الثالث الذي استمدت منه البنيوية، ولعلها أهم هذه المصادر، وعلى الخصوص ألسنية فرديناند دي سوسير (1857-1913) الذي يُعد أبا الألسنية البنيوية، لمحاضراته (دروس في الألسنية العامة) التي نشرها تلامذته عام 1916 بعد وفاته. وعلى الرغم من أنه لم يستعمل كلمة (بنية) فإن الاتجاهات البنيوية كلها قد خرجت من ألسنيته، فقد مهد لاستقلال النص الأدبي بوصفه نظاماً لغوياً خاصاً. وفرق بين اللغة والكلام: (فاللغة) عنده هي نتاج المجتمع للملكة الكلامية، أما (الكلام) فهو حدث فردي متصل بالأداء وبالقدرة الذاتية للمتكلم.
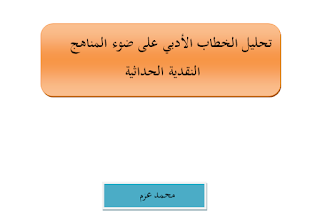
تعليقات
إرسال تعليق